عيد عبد الحليم: لا أفكر فى جوائز الدولة.. وأحلم بجائزة نوبل (حوار)

أصدر الشاعر عيد عبد الحليم أحد عشر ديوانا ضمن تجربته في القصيدة النثرية، ويعمل حاليا رئيس تحرير مجلة "أدب ونقد، ورئيس القسم الثقافي والفني بجريدة "الأهالي"، من أعماله “ظل العائلة، تحريك الأيدي، العائش قرب الأرض، كونشيرتو ميدان التحرير، موسيقى الأظافر الطويلة، حديقة الثعالب، حبر أبيض، شجر الأربعين، بيد واحدة أتصفح بريد الحرب، “الدستور” التقته وكان هذا الحوار.

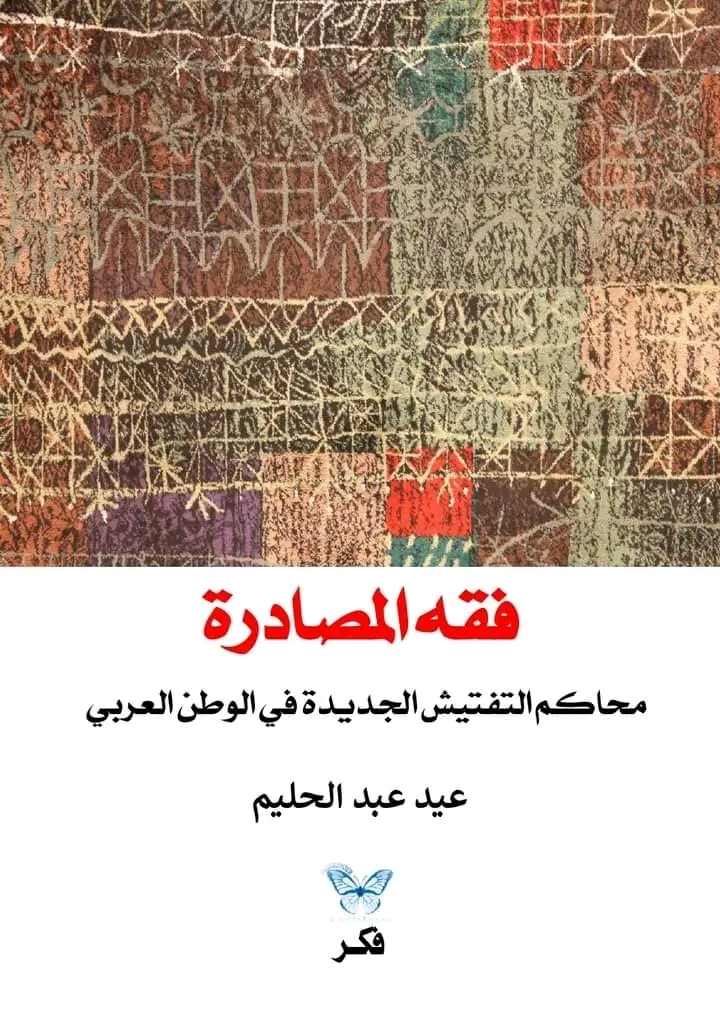
- بعد صدور “مزرعة السلاحف”، ماذا يمثل لك هذا الديوان في دلالات قصيدة النثر التي تعمق في مسارك الشعري بفرادة التجارب- ذاتية/ فنية/ وجودية؟
الديوان هو الحادي عشر في تجربتي الشعرية، التي أعتبرها قوسا مفتوحا على التجريب المستمر، وهذا جوهر الفن من وجهة نظري، أن تظل تحاول وتحاول، ولا تصل لإن الوصول يعني مجانية الحياة، يعني العادية، إنما المحاولة أن ترى الأفق وتحاول الوصول إليه، هنا يكمن جمال الإبداع، لأنك كمبدع في تلك اللحظة تكون أنت خالق الجمال الذي يبتكره خيالك، وأعتقد أنني عشت حياتي كلها محاولا البحث عن أفق يخصني أشكله جماليا بقدر معاناتي في رحلة الوصول، وبقدر انكساراتي وأوجاعي كذلك فرحي الدائم بهذه الحياة، التي بخلت علي بأشياء كثيرة لكنها منحتني نعمة كبرى وهي "البحث" والتأمل، وفلسفة تشبه طفولتي الغاربة، مثالية أحيانا، لكنها لا ترضي بالغرباء، من هنا جاءت سلسلة دواويني الأخيرة وهي "شجر الأربعين" والذي طرح فكرة أزمة منتصف العمر، في مرحلة أراها أجمل مراحل عمر الإنسان وهي سن الأربعين، حيث يصل العقل إلى قمته، والشهوة إلى ذروتها، والعاطفة تخترق كل الحواجز، خاصة مع برج ناري مثل "الجوزاء" والذي انتمي إليه، وأعتز بتقلباتي العاطفية، ومغامراتي التي لا تهدأ، التي تبدأ بنار مشتعلة ثم تتحول إلى شمعة ترافقني عند كتابة القصيدة.
- ماذا عن رؤيتك لقصيدة النثر ؟
قصيدة النثر يناسبها تماما، برج الجوزاء لأنها تفور بشهوة الخيال، لا يحدها شكل أو مضمون، لا حدود تعريفية لها، بل هي تعرف نفسها وفق الشاعر الذي يكتبها، فهي مثل إمرأة لعوب لا يستطيع كل الرجال ترويضها، وهناك شخص واحد هو الذي يمتلك مفتاح غوايتها، الشاعر الحقيقي يقف في تلك المنطقة، وفق قدرته التخيليلية وثقافته المعرفية، وتجاربه المتعددة، أنها قصيدة الخبرة والخيال الجامح والثقافة الموسوعية، تلك الثلاثية إذا اجتمعت في شاعر ثق تماما أنه سيكتب قصيدة نثر.
- هل لحياتك، دورا في اختياراتك الإبداعية أو الفكرية؟
أنني ابنًا الألم، منذ الطفولة، عانيت من اليتم ولم أكمل العاشرة، هزني موت والدي، لكن كان وجود أمي دافعا لي على حب الحياة، ومع ذلك بعد وفاتها من شهور قليلة، وها أنا الآن، في سن الثامنة والأربعين، أشعر بيتم أكبر،فتلك المرأة الريفية البسيطة –أمي- كانت جمهوري الأول وجائزتي التي لا تقدر بجوائز العالم كلها، من أجلها كنت أتفوق في الدراسة، من أجلها أحفر في الصخر حتى أنجح في عملي، كنت أنجح من أجلها وأكتب الشعر، حتى أقول لها هذا الشعر بعض عطاياكي.
- مساراتك المتعددة، ثقافيا / إبداعيا، ما هو أقربها ويتواءم مع الحراك الفكري في خطاك التي ترى فيها ثمة خلاص؟

• ليس هناك أفضل من صفتك الإبداعية، فأعتز أولا كوني شاعرا، لأنه من أجل الشعر تركت أشياء كثيرة، تركت بلدتي وأمي وأخواتي البنات وكنت أكبر الأبناء سنا والولد الوحيد، جئت إلى القاهرة أراهن على موهبتي الشعرية، ومنذ اليوم الأول قيض الله لي من آمنوا بموهبتي، ففي دمنهور وجدت الناقد السيد إمام الذي نشر لي أول ديوان وهو "سماوات واطئة" في بدايات النشر الإقليمي بقصور الثقافة، ثم عقد لي ندوة لمناقشة الديوان بحضور الشاعر صلاح اللقاني، ووسط الحضور قدمني السيد إمام قائلا: "هذا الشاعر الشاب صغير السن سيصبح في الأعوام القادمة أهم شاعر في مصر نظرا لموهبته المتفجرة". ويضيف الشاعر عيد عبد الحليم.
وفي القاهرة وأثناء دراستي في السنة الأولى الجامعية ذهبت إلى ندوة جرية المساء الشهرية التي كان يقيمها المفكر د. فتحي عبد الفتاح، والذي قاتل للحضور بعد إلقائي لقصيدتي، هذا الشاب عيد عبدالحليم منذ اليوم ليس عنده مشكلة في النشر، فهو صلاح عبد الصبور الجيل الجديد.
- كيف كانت بداياتك مع النشر ؟
عندما ذهبت لمجلة أدب ونقد عام 1996، وكنت في السنة الثانية من الجامعة، أخذ من الشاعر حلمي سالم قصيدة، ظل العائلة، وبعد أسبوع مررت عليه في مقر المجلة فإذا به يريني بروفة لمجلة اسمها "إضاءة 77" وإذا بقصيدتي منشورة فيها تجاور قصائد أمجد ناصر وجمال القصاص وفريد أبوسعدة وسيف الرحبي وقاسم حداد ودراسة لإدوار الخراط.
وحين ذهبت-بعد أيام- لهيئة قصور الثقافة عارضا عليه ديواني "ظل العائلة" للنشر في سلسلة "إبداعات"، وكانت معي نسخة من "إضاءة 77"، وحين تصفحها الروائي الراحل فؤاد قنديل وكان رئيسا لتحرير السلسلة، قال هذا الديوان ينشر على مسؤليتي، لإن من ينشر في إضاءة 77 مع أهم شعراء في العالم العربي لا يدخل ديوانه لجنة قراءة.
من هنا يأتي حبي لمساري في الصحافة الثقافية، التي أمارسها ليس مجرد مهنة بل رسالة، وسعيد بكوني كنت أصغر رئيس تحرير لمجلة ثقافية متخصصة في تاريخ مصر الثقافي حين توليت رئاسة مجلة "أدب ونقد" من ثلاثة عشر عاما، ذلك المكان الذي أعتز بجلوس أستاذة كبار عليه مثل الدكتور الطاهر أحمد مكي والناقدة فريدة النقاش والشاعر حلمي سالم.
ويأتي المسار الثالث في الفكر والنقد، مسار التعلم والرؤية المستقاة من الدراسة المنهجية، وقد سعيت للالتحاق بالمعهد العالي للنقد الفني وأتاممت الدراسات العليا به ودرست النقد على يد كبار أمثال د. شاكر عبدالحميد ود.سامح مهران ود. زين نصار، مسارات مختلفة في النقد الأدبي والمسرحي والموسيقي، مما عمق من خبراتي في هذا المجال.

- عن مفاهيم النشوة/ الخلاص- السلوى- هل ينتهي وتنتهي أحلام المبدع بالخلاص بعد انتهاء كتابة نصه؟
- نشوة الكتابة لا تنتهي بالكتابة، فالكتابة هي العتبة الأولى للنشوة، بل لصناعة النشوة، النشوة الحقيقية بالنسبة للمبدع أن يرى أثر ما يكتبه على القاريء. هنا يصل إلى غاية النشوة.
أما فكرة الخلاص فهي فكرة أزلية ارتبطت بالكتابة منذ العصر اليوناني القديم، وهي ما سماها "أرسطو" بالتطهر، هي حالة من تخفيف الألم والوجع الداخلي وليس إزلته، بدليل أن المبدع بعد فترة قد يعود لقراءة نصه فيحس بنفس الألم الذي سبق لحظة الكتابة.
أما بالنسبة لي فقد حددت وجهة إرادتي من الحياة منذ أن كنت صبيا في العاشرة من عمري، فرسمت خط الأمنيات لنفسي وأنا في نهاية المرحلة الابتدائية. بحيث قلت في نفسي: الشعر خلاصي من اليتم والفقر وسبيلي للتعايش مع هذه الحياة الصعبة.
منذ أن بدأت أكتب الشعر كان حلمي أن أصبح كاتبا وأديبا، مثل طه حسين وإحسان عبد القدوس وصلاح عبد الصبور ونجيب محفوظ وعباس محمود العقاد ولوركا وبودلير ورامبو وهرمان هسه وغيرهم.
هؤلاء كانوا أصدقاء طفولتي من خلال كتبهم التي بدأت أقرأها في هذه السن المبكرة بشغف وعمق، فتغير وعي الصبي الذي ترك ملاعب الطفولة مع رفاق سنه من زملاء المدرسة والأقارب ليعيش مع ما هو أكبر من سنه.
بدأ يبحث عن المعرفة في كل مكان فذهب إلى قصر الثقافة في مدينته البعيدة وقرأ كل الكتب الموجودة في مكتبة قصر الثقافة خلال ثلاثة أعوام.
في تلك الفترة ومع دخولي للمرحلة الثانوية بدأت أكتب الشعر بغزارة؛ لدرجة أنني جهزت ديوانا للنشر وكان عمري وقتها ستة عشر عاما؛ أعجب صديقا لي كان يكبرني بعشر سنوات كان قد تخرج من كلية اللغات
والترجمة، قال لي: سوف نذهب إلى القاهرة ونقدم هذا الديوان للنشر في الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ وبالفعل ذهبنا وقابلنا مدير النشر بالهيئة وكان وقتها الأديب "محمود العزب"، الذي فوجئ بأن كاتب الديوان هو ذلك الصبي الصغير، وقال لي كلمة أتذكرها حتى الآن وهي: رغم صغر سنك إلا أنك تكتب بلغة مختلفة.
وكان يجلس معنا بالمصادفة الشاعر العمودي الشهير محمود توفيق- وقد كان ضابطا في القوات المسلحة، وهو شقيق علية توفيق زوجة يوسف صديق أحد القادة المهمين لثورة يوليو-، وقال لي ساعتها: أنت مستقبل للشعر العمودي في مصر
تلك الرحلة كان لها أثر واضح بعد ذلك على حياتي، فقد أكدت لي أنني أمضي على الطريق الصحيح، فقررت عند حصولي على الشهادة الثانوية أن التحق بالجامعة في القاهرة كي أكون قريبا من منافذ النشر في الجرائد والمجلات، وقريبا أيضا من المنتديات الثقافية.
-أنت من جيل التسعينيات الشعري في قصيدة النثر، حدثنا عن أقرب القصائد التي تتماس أو تملك ثمة توحد لحواسك وفكرك، وهذا من خلال رفاقك من الجيل؟
- لا بد أن نؤكد في البداية أن شعراء قصيدة النثر بعضهم كان من أبناء جيل الثمانينيات لكن القفزة النوعية عندهم جاءت مع بداية التسعينيات في قصيدة النثر مثل إبراهيم داود ومحمود قرني، وعلي منصور وفاطمة قنديل وإيمان مرسال، أما من جيل التسعينيات فأنا أرى أن هناك أسماء هي الأكثر عمقا وتجربة مثل عزمي عبد الوهاب وكريم عبدالسلام وعماد أبوصالح وفتحي عبدالسميع ومحمود خيرالله وعاطف عبد العزيز وتجربتي أيضا هذه الأسماء تحديدا منحت قصيدة النثر المصرية خصوصيتها. وأمدتها بطاقة شعرية هائلة وحولت مسارها من خطاب الذات إلى خطاب الواقع، من قصيدة مغلقة على نفسها، إلى قصيدة منفتحة على العالم وقضاياه المختلفة.
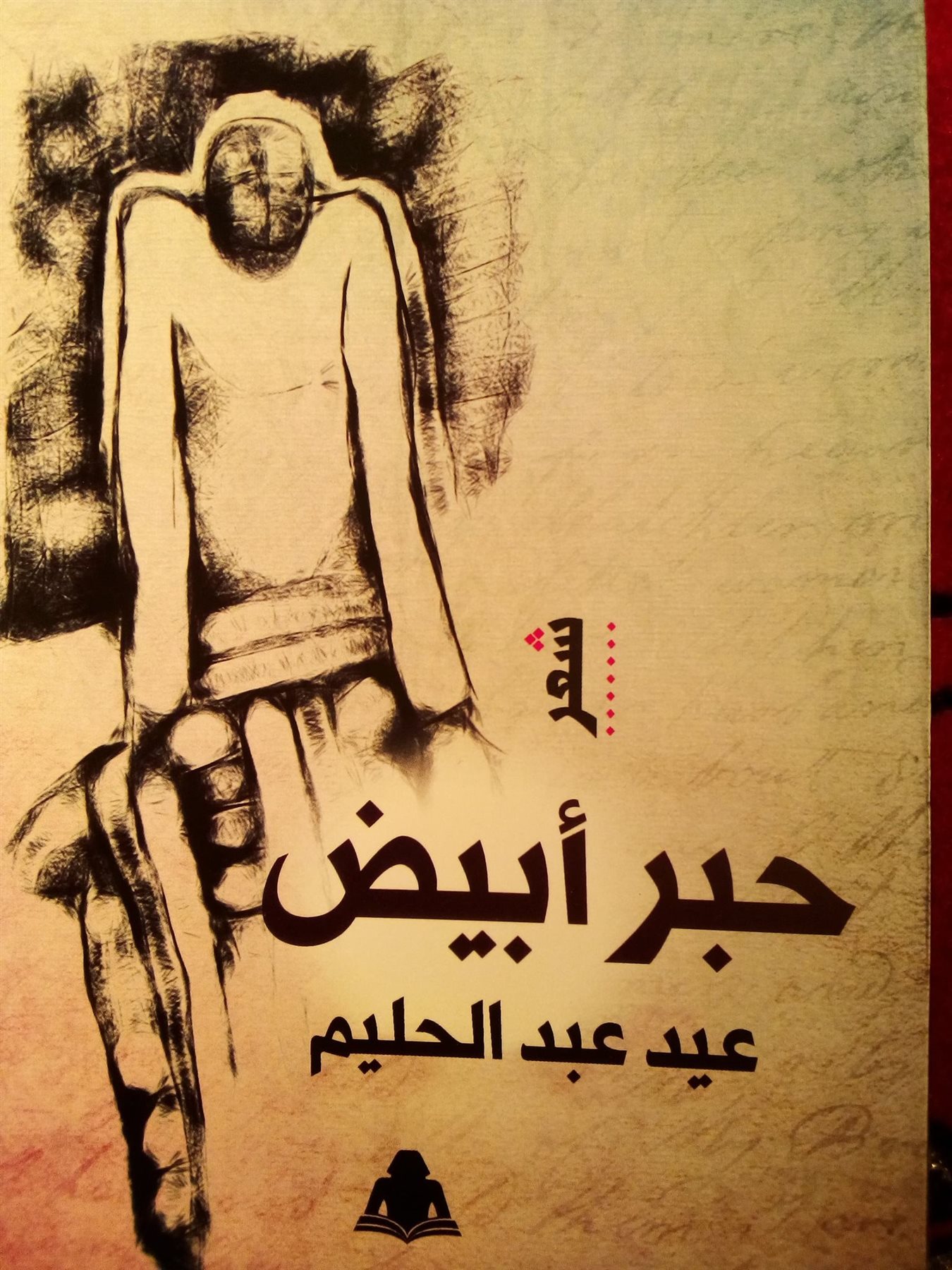
- ليتك تفسر لنا دور الحروب ودوافعها في التأثير على مكانة الفن والفكر والآداب، وحركات الإبداع الشعري تحديدا؟
- في ظل الأزمات الإنسانية الكبرى يظهر الدور الأكبر للإبداع، ولعل أسرع الفنون تأثرا بذلك هو الشعر لأنه الفن الإنساني الأول حسب الفطرة الإنسانية.
وقد أثبتت الوقائع الأخيرة وما حدث في غزة، أن الشعراء أكثر المبدعين في العالم العربي تحديدا تعبيرا عما حدث.
المبدع مؤرخ بالخيال، وفي الوقت الراهن أصبحت الكلمة شرف للمبدع - على حد تعبير عبدالرحمن الشرقاوي-، فالمبدع عليه ضريبة في اللحظات الصعبة والبشعة عليه أن يؤديها بكلمته، وأسرع الكلمات وصولا للجماهير كلمات الشعر.
- لك اهتمامات جمة في بنية الاشتباك مع عوالم المسرح المصري تجلياته، ليتك تقيم أطر وحراك الأشكال المسرحية، وكيف تراها؟
- أنا عاشق للمسرح، والوحيد من شعراء قصيدة النثر الذي كتبت مسرحا شعريا، عندي أربع مسرحيات شعرية، أولها "الجرافة" فازت بجائزة توفيق الحكيم للمسرح من وزارة الثقافة.
كذلك مؤلف أول كتاب في المكتبة العربية عن الفرق المسرحية المستقلة، وصاحب أول كتاب عن "مسرح الشارع في العالم العربي" والذي طبع منه 40 ألف نسخة، الكتابان هما المرجع الأول الآن في مجالهما.
وجاء اهتمامي بالمسرح متواكبا مع اهتمامي بالعنصر الجمالي في فعل الكتابة بشكل عام، وإذا كان العنصر الجمالي "يسود في المجتمعات التي تتمتع بصحة جمالية إبداعية" ـ على حد تعبير بيتر فوللر ـ فإن تجربة المسرح الجديد في مصر قد خلقت فضاءات مغايرة في الرؤية والكتابة والأداء والإخراج، وإن جاءت هذه الفضاءات ـ في كثير من الأحيان ـ خارج المسرح الرسمي الذي يعاني منذ أكثر من ثلاثين عاما من التدهور نتيجة لغياب الوعي بأهمية المسرح في الحياة، فأصبحت كثير من مسارح الدولة تعيد إنتاج ما سبق، وفي بعض الأحيان تغلق أبوابها لأنها لا تجد ما تقدمه، أو هكذا تظن، وكأن معين الإبداع قد نضب، وتصبح المسألة في النهاية مجرد ميزانيات وموازنات مالية يجب أن تسوى في نهاية كل عام وفقط.
- كتبت عن مؤسس الرواية العربية الحديثة أديب نوبل نجيب محفوظ، فماذا تقول عن سروده؟
- إذا كانت الأمم تقاس بأيامها المجيدة فإن كل لحظة من عمر نجيب محفوظ كانت تساوى طاقة نور للوطن. وكل لحظة تقع عين القارئ فيها على عالمه الروائى تعد تكريما لنا قبل أن تكون تكريما له.
وإذا كان حصوله على جائزة نوبل فى الآداب عام 1988 يعد الحدث الأكبر فى الثقافة المصرية المعاصرة، فإن ذلك يدعونا للتساؤل عن كيفية الاحتفال بهذه الطاقة التى طالت سماء التألق.وقد كان " محفوظ " من هذا النوع الذى أهلته الظروف لأن يقف فى منطقة إبداعية يمكن أن أسميها بـ" فلسفة الوجود ودراما الشخصية " حيث تتحول الذات المبدعة إلى مرآة عاكسة لبنية المجتمع تغوص فى تفاصيله المكانية والزمانية لتعيد صياغة أبعاده الدرامية عبر لغة تنتج من الأبعاد الشعبية لهذا المجتمع، فتصبح لغة السرد فعلا موازيا للغة الشارع، ومن هنا ينفتح فضاء الدلالة، وتجئ رحابة المعنى، وقد حاولت توضيح كل هذه المعاني في كتابي "رسائل نجيب محفوظ بين فلسفة الوجود ودراما الشخصية".
- بعد مرور أكثر من اثني عشر عاما على توليك رئاسة تحرير مجلة "أدب ونقد" كيف ترى صدى حراكك بل وتجليات تلك المسارات الإبداعية والفكرية- الأيديولوجية التي تعمل عليها؟
- أسعيد للغاية بتجربتي في "أدب ونقد" التي أعتبرها مشروعي الصحفي الأول، وأحد أبنائي بعد أحمد وأروي، حبها لا يقل عنهما، أعطيتها أكثر من نصف عمري منذ أول حرف نشرته في نوفمبر 1998م، وحتى الآن، تعلمت فيها من حلمي سالم التسامح والرحابة، وتعلمت من فريدة النقاش الصبر ورعاية الموهوبين، وتعلمت من رفعت السعيد احترام الآخر وعمق المعرفة، سعيد بهذه المدرسة التي كنت في يوم من الأيام أقف أمام بوابتها، ثم أصبحت تلميذا فيها، حتى أصبحت الآن حارسها، ما منحني الثقة في مواصلة المشوار الصعب وهو حب المثقفين، وتكاتفهم معي من كل أنحاء الوطن العربي، ما أجمل أن تكون صانعا للحراك الثقافي في بلدك، وما أصعب أن تكون في زمرة النخبة المثقفة المؤثرة في مصر.
- أين أنت من جوائز الدولة؟
- للأسف الأمر مضحك، جوائز الدولة في واد والإبداع الحقيقي في واد، تصور أن جيلنا من شعراء قصيدة النثر، لم يحصل فيه شاعر حتى على جائزة الدولة التشجيعية، مثلي وأبناء جيلي في البلدان العربية يحصلون الآن على جوائز الدولة التقديرية.
مثلنا وربما أقل منا إنتاجا وتأثيرا يرشحون لجائزة نوبل في دول العالم، ونحن للأسف ما زالت المؤسسات الرسمية التي يقودها موظفون لا يعرفون شيئا عن الثقافة يعتبرون المسألة سد خانة وملء أوراق، فأنا لا أفكر بجوائز الدولة، بل أحلم بجائزة نوبل.






















