حسني حسن: البيوت هي التي تسكننا.. واستكمل مشروع روائي عطله عملي الدبلوماسي (2)

حسني حسن، الكاتب والروائي، الذي تمرد على الكثير من التقاليد البالية سواء في الحياة أو الكتابة، فصنع لنفسه نموذجا واحتذى بنفسه، كما تمرد سرديا فراح يدمج الفلسفة بكتاباته عبر سرد مغاير نبع من وعي بعالم الكتابة.
حسني حسن الذي تخطى عامه الستين، راضياً منتشياً بفرح الكتابة، مستسلماً لأهوائه فقط غير مكترث بالتصنيف ولا فحوى النقد ولا حتى الانتماء لثمة تيار كتابي، رافضاً وبشكل حاد وقاطع الدخول في متاهات الشللية، وأن يكون نفسه ولنفسه فقط، “الدستور” التقت حسني حسن وكان هذا الحوار..
هل تشعر بالتقصير تجاه إبداعاتك وما هي مسئولياتك ككاتب عن إهمال موهبتك بتلك الخصومات الحادة والجادة تجاه الفاعلين في الثقافة والإبداع؟
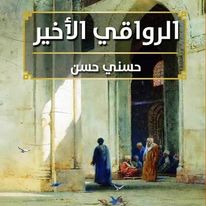
الشاهد أني عندما رجعت للكتابة، وبالرغم من نبوءة أحدهم لي بأني قد غدوت خارجها كلية لانشغالي بجمع المال، وجدتني مندفعاً لتجربة أشكال وأنواع أدبية جديدة علي كالقصة القصيرة والشذرات التأملية، وأصدرت في سنتين ثلاثة كتب هي على التوالي: "يتامى الأبدية" و"بهو المرايا" ثم "الرواقي الأخير"، أظنهم لم تتم قراءتهم بعد، أخشى أنهم لن يتم قراءتهم حتى لحظة موتي، لكن لا بأس، فكل شئ، في هذا الكون الشاسع، يرتبط بكل شئ آخر، على هذا النحو أو ذاك. كل شئ هو، وبكيفية ما، نتاج كل شئ آخر، وكذا، علة كل شئ آخر. وحتى صمتي وانزوائي وكسلي وتقاعسي، لابد وأنها جميعها ستسهم في اختراع شئ ما لم أكن لأحلم بالمشاركة في حدوثه، أو ربما في وقوع جريمة ما لم أكن أتخيل إمكانية تورطي فيها. وهكذا، فإنيأقبع بقلب الكون ذاته، وبالرغم من أني قد لا أعي موقعي ذاك. ومن هنا تأتي مسؤوليتي عما يجري فيه؛ من الذرة إلى ما وراء المجرة، ومن الشهود إلى الجحود. كل شئ يبدأ منيوفي، كما لا ينتهي بي وعندي، وهكذا أحذر نفسي مُلقِناً: إياك والإهمال، حتى وإن صارت عقيدتك هي الإغفال.
_ عن جيل التسعينيات، ماذا بقى من مجايليك وهذا إن كمن تؤمن بتلك المسميات ومن يروق لك كتاباته والتواصل معه؟
الحقيقة أني لا أشارك الكثيرين قناعتهم الرائجة هذه بشأن التقسيمات الجيلية للأدباء، وأعتبرها نوعاً من المسعى الكسول لتجنب مخاطر ومشاق البحث عن الأصالة الذاتية والفرادة الإبداعية. يتردد عادة القول إنك لو أردت قتل أحداً ما، أو فكرة ما، فعليك بتسميتهما ابتداءً. تلك التسمية التي لا تنجح إلا في اختزال الناس والأشياء، في مص عصارات ونسغ الحياة بعروقهم، ومن ثم طرحهم متيبسين على الطرقات، تحت النعال الثقيلة، وأطراف الألسن. قد تكون مجرد مصادفة قدرية حقيقية أن يجتمع عدد من المبدعين ضمن إطار تاريخي، أو جغرافي، أو حتى فني وتقني بعينه، على النحو الذي يدعو لمحاولة ضمهم معاً. وقد يكون في الأمر مؤامرة ما، وأنا لا أستبعد أية فرضية لمّا يتم التحقق منها بعد. وقد يكون أخيراً، وهذا هو المرجح عندي، مجرد كسل عقلي وعادة ذهنية علي ألا أتوقف عندها طويلاً.
بالنسبة لي كقارئ، فإني أعتبر نفسي قارئاً محترفاً وكاتباً هاوياً، وعليه فإن القراءة التي تشغلني، وتأخذني، هي القراءة التي أستمتع بها، وأتعلم منها. بطبيعة الحال أتابع الجديد، وباستمرار، مما يصدر من كتابات، عربية أو عالمية، في فنون السرد بخاصة. لكن هذا لا يتم وفق أية منظورات جيلية، ولا حتى تقسيمات تقييمية، حداثية أو تجريبية أو طليعية أو كلاسيكية...إلخ. أبتعد غالباً، ولفترة زمنية كافية، عن العناوين التي "تفرقع"، عارفاً أنها، عادةً، محض ظواهر ترويجية يقف من ورائها ناشر ما، أو تغذيها أجندة سرية ما، أو حتى، وكما أشرت عاليه، مجرد كسل عقلي. بالمقابل، أعاود قراءة الأدب الكلاسيكي مرة بعد مرة، بكل شغف. قرأت "الحرب والسلام" في ترجمتها الكاملة للدروبي والجهيم لسِت مرات، وأحدس أني لمّا أنتهي منها بعد، وكذلك "ثلاثية محفوظ وحرافيشه" أربع مرات لكل منهما، وهذه مجرد أمثلة وحسب. خلاصة القول، إني أضن بوقتي، وطاقتي، المحدودين أن أهدرهما فيما أتوقع انعدام القيمة به بعد مطالعة بضع صفحات منه. دربت نفسي جيداً على قراءة ما لا يستحق القراءة بسرعة كبيرة تليق به، والعكس صحيح أيضاً.

- وما هو المعنى أو الجدوى من ظلال صورتك في عيون الآخر المستقبل لنصوصك، وما هي الغاية من الكتابة؟
لا أعرف، حقيقة، كيف يفكر الكتاب في معنى، أو ضرورة، الكتابة بالنسبة لكل منهم. بالطبع قرأت الكثير مما صرحوا به عن أهمية وغايات الكتابة عندهم، لكني، وأصدقكم القول، أبقى متشككاً فيما يقولون، بقدر أو بآخر، على هذا النحو أو ذاك. أشرت سابقاً إلى إبسن النرويجي الذي اعتبر الكتابة جلسة لمحاكمة الذات وإدانتها، ولم أذكر ما قال به ماركيز عن إنه يكتب، فقط لكي يحبه أصدقاؤه أكثر، أما لورانس داريل فقد اعتبر الكتابة نوعاً من الهروب، وتشارك معه في ذلك جراهام جرين الذين عنون كتابه عن تجربته الكتابية بعنوان "سُبل الهرب". تسألون عن ملاذ الكاتب بعد الفراغ من كتابته فأقول لكم إنه إذا كان الفراغ الجحيمي يصلح لتسميته ملاذاً فهذا ملاذي. أنخرط بالكتابة راجياً التخفف من ضغوط لا تحتمل وأثقال لا تطاق تدوم بالرأس وتعصف بالروح. أكتب ببطء وبتدقيق بالغ، في معظم الأحوال، وبسرعة منذهلة عن ذاتها في بعضها. أكتب آملاً نفض الحمول والحمم، مُستهدفاً تفريغ الذات وتبريدها، وموقناً باستحالة مضاهاة ما على الشاشة أمامي بما يعتمل بالعقل والروح. لا أفكر بأي قارئ، من أي نوع كان، حين الانغمار بالكتابة، لكني أظل أترقب ذاك القارئ، وأتطلع لمعرفة رأيه بعد الانتهاء. لا أرجو ثناءً ولا مديحاً منه، فقط مشاركة في الانفعال، أو في الإدراك. لا، ليست الكتابة سلوى، ولا تسرية، وإنما استجابة لا إرادية، وقسرية، لضغوط مجهولة تستعصي على الاحتمال. هي حياة شاقة وبائسة من دون شك؛ أن يبقى المرء مقهوراً على إتيان ذاك الفعل الذي يبدو وكأنه لا جدوى منه، ولا طائل من ورائه. أفكر بألم، ولذة بنفس الوقت، كيف أني، وكما فاوست، قد رهنت نفسي لميستوفليس الوظيفة، لعشرات السنين، بوعد أن أنجح أخيراً بتأمين وضع اجتماعي غير ضاغط أتمكن معه من معاودة أملي في الكتابة الإبداعية التي لم، ولن، أربح منها جنيهاً. هل هي عملية التطهير التي يزعمها أرسطو؟ جائز، لكن لا بالنسبة لي. نعم ثانية، ما من عزاء، ولا سلوان. فقط جحيم الفراغ، تام العتمة، المفرغ الهواء.
_ عن بدايات التكوين والمولد طنطا/ الإسكندرية، كيف ترى وتفسر مفاهيم البنية النفسية والحياتية والذاتية في شكل ومحتوى ما تطرحه من كتابة؟
من قال إننا نسكن البيوت؟ إنها هي التي تسكننا. نولد، ونعيش، وربما نموت، فيها، لكننا نبقى مسكونين بها، منذ البداية، وحتى ما بعد النهاية. أعتقد أن ليس في كلامي أية مبالغة بلاغية، ولا كناية، بالنظر إلى ما يتردد أحياناً عن زيارات أرواح، أو أشباح، الموتى لدورهم وبيوتهم، فما لمثل تلك الزيارات من دواعٍ، ولا تفسيرات، سوى أن الجوهر الخالد فيهم يظل مسكوناً بالبيوت التي كانت حين كانوا. أمَا عني
فلطالما أشغفتني تلك الغرفة الموصدة في أقاصي الدار. تشغفني وتثقل ليالي طفولتي بالسؤال عمَا يختبئ بظلمتها وصمتها العميق من أسرار وأعاجيب، وحتى وأنا تباغتني، للحظات، فكرة أنه ربما لا وجود خلف ذلك الباب الخشبي الثقيل، بقفله النحاسي الضخم، إلا للخواء، أو لعوائل الفئران التي ترتع في جنتها الموهوبة بأمان، أو للعناكب، سأبقى أسير المخيلة الشغوف: ولماذا أستبعد احتمال أن يكون الجد الطيب لا يزال راقداً فوق سريره العالي الكبير هناك، يُصغي ويرقب في الحُلكة؟ لماذا لا تكون الفراديس التي يُعلمني مدرس الدين أنها قد أعِدت للمتقين ليست في السموات العالية المُضيئة، بل في الغُرف العتيقة المفتونة بدنوها، ودنيويتها، الرخيصة القريبة؟ أو حتى لماذا لا تكون سَقر المرهوبة؟
وها أنا الآن، وقد ودعتك جهالات الطفولة وخيالاتها الرحيمة، وعبرتَ بآلام جديدة، لم أجرب أهوالها من قبل، عتبة الستين، أظل على شغفي الصبياني النزق باكتناه أسرار تلك الحجرة، القديمة قِدم العالم ذاته، الخالدة خلود الأكوان، والزائلة كقشرة ثمرة موز عطنة، رافضاً تصديق أن الجد العجوز لا يقطنها بعد، لم يقطنها أبداً، أو أنه لم يُقيض له يوماً أن يتجلى فيها، ولا في أي فضاء حالك الظُلمة المنيرة غيرها.
_كثيرا ما تكتب وتتحدث عن جدوى السكن والمسكون في المنازل والبيوت، قل لي كيف ترى مفاهيم العيش وكيف كانت طفولتك ووجودك الإختياري بمدينة الأسكندرية؟
صحيح أني عرفت لي بيوتاً عديدة، في طنطا، في الإسكندرية، في القاهرة، في الخرطوم، وفي الرباط، إلا أنه، وبمجرد ذكر لفظة البيت، لا يتبادر إلى ذهني منها غير اثنين: الأول بيتنا الكبير العتيق في طه الحكيم بقلب طنطا، والثاني بيت زواجي عند شاطئ الإبراهيمية بوسط الإسكندرية. الإثنان صارا لا وجود لهما إلا في ذاكرتي المُسِنة، وفي الإثنين جربت حقاً مسرات العيش، ألعاب الطفولة وشقاواتها، صبوات المراهقة ونزقها، أحلام الشباب وأوهامه، الحضور الكثيف للأم وللزوجة المحبوبتين، الغياب الأليم للأب، سهر الليالي الطويلة في مراجعة الدروس والاستعداد للامتحانات، الشغف بقراءة مجلة سمير ثم روايات “دوستويفسكي” و"هرمن هسه"، الإصغاء لزخات مطر، لنوات الإسكندرية العاصفة على إسفلت الطريق وشيش النافذة، بكاء التوأمين ثم حبوهما ثم انتصابهما واقفين، وآلاف آلاف التفاصيل والذكريات الصغيرة الحميمة الأخرى. إنها جميعها حياتي. فإذا كان الأدب بمثابة قص أثر الوجود العيني لإدراكه على نحو أعمق، ومن ثَم التسامي به صوب الخلود والديمومة المتجاوزة للأزمنة وللأمكنة، فلعل هذا يبقى أهم شواغلي، وهواجسي، الأدبية، لأعلو بالمكان والزمان من سُكنى الحجارة والساعات إلى سُكنى الأوراق والتصورات. أجل، فلكل موجود بيتٌ يسكن فيه، يروح ويغيب ويرجع إليه، ويدخل، فيا له من بؤس مجيد، أن تُضيع مفاتيح سكنك بإرادة وهمك، ثم تروح تؤسس لمجدك بيت من كلام على قواعد بائسة من حبر وورق. أن تنشد النجاة بالغرق. أو أن تتوق إلى كل ما ليس أنت!
_ وماذا عن علاقتك بالجوائز وصناعاتها وآليات المنح والحجب؟
أشكركم لطرح هذا السؤال، وأعتبرها فرصة جيدة للتعبير عن رأيي المتواضع في هذه المسألة التي تثير الكثير من الصخب، ولا تنتج إلا أقل القليل من طحين الأدب الحق. لقد قلتها من قبل، وأكررها:
تنفي صناعة الجوائز الأدبية فكرة أدبية الأدب، مُحيلة إياها إلى مجرد صنف استهلاكي آخر، رخيص وحرَاق وسريع التلف، يمكن رصه فوق أرفف السوبر ماركت العولمي، شأنه شأن الملايين من المنتجات والخدمات الرأسمالية، والتي لا حاجة للإنسان فيها فعلياً، وإنما يصر رأس المال على مواصلة إهدار الموارد، الطبيعية والبشرية، بشكل سفيه ومجنون، ليحافظ عبر التوسع في إنتاجها على نموه الذاتي الشره، وحسب.
وتنفي هذه الصناعة أدبية الأدب، على نحو خاص، في البلدان المتخلفة والتابعة، كما بلداننا، مُستغِلة حاجة أنصاف أرباع الموهوبين من الكُتاب، وأطماع أشباه الناشرين، وسطحية وتفاهة جيوش صبيان الصحافة، الورقية والرقمية على السواء، لاحتياز المال وتحقيق بعض الشهرة العابرة، وهي الحاجة التي سيحاول بعضهم تبريرها، وتمريرها، لنا بادعاء وعيهم المُسبق بحقيقة انعدام قدرة تلك الصناعة على إنتاج أدب إنساني حقيقي، ورغبتهم، في الفوز، فقط، بحوافزها الدولارية من خلال مشاركتهم النشطة في هذه المقاولات الحداثية وما بعد الحداثية.
وتنفي تلك الصناعة الأدب وأدبيته بالذات حين تحيلهما إلى مقاولة تعبيرية وكلامية، طامحةً، وهنا تكمن المفارقة، المضحِكة المُبكية، إلى كسب تعاطفنا وتقبلنا، الفكري والوجداني، لصالح مقاولي الكلام والصور والرموز، بأكثر من تعالينا، الفكري والوجداني كذلك، على نظرائهم من مقاولي الأسمنت والحديد والسلاح، مثلاً. ويضيف الكاتب الجسور المتمرد الروائي حسني حسن.
أخيراً، هي قوانين السوق، لا قوانين الوجود الطبيعي الحر للإنسان وللإنسانية. فمن أراد، وارتضى، العيش وفقها فهو وما يريد، فقط فليرحمنا ولا يزحمنا إنْ بأفراحه، أو بأتراحه، وليدعنا في هدوء مساعي إعادة ارتشاف الكتابات الحقيقية، ومهما بدت لماكينة تلك الصناعة الرديئة قديمة أو كلاسيكية.

وربما يقودنا هذا التحليل، مباشرة، إلى طرح المزيد من الأسئلة، الإضافية والهامة والمسكوت عنها، حول الجوائز: من يمنحها؟ ولمن؟ وبأية كيفية؟ وتحقيقاً لأيةأهداف؟
وبالنسبة للسؤال عمَن يمنح الجوائز، فلعل الإجابة،وباختصار ووضوح، هي أن الشخص الذي يمنح قيمة الجائزة المالية، أقصد الشخص الحقيقي أو الاعتباري، لابد وأن يصير، في نهاية الأمر، إلى تحقيق رمزية لذاته، متجاوزة لحقيقة ذاته، وهو، وبالضرورة، يمنحها انطلاقاً من أجندته الخاصة، مهما ادعى،أو أنكر، أوحاول إثبات أن الأمرعلى غير ذلك، فيما أن اللجنة التي تُكلف باختيار الأعمال الفائزة وتقرير لمن تذهب الجائزة وتضع معاييرها لذلك، هي، وحتى بافتراض حسن النوايا والأهلية والجدارة العلمية، وهي من الأمور المشكوك فيها بلجان جوائزنا العربية بالخصوص، ليسوا أكثر من خمسة إلى تسعة قراء من بين ملايين قراء النصوص المُنتَجة المحتملين، ومن ثم فهي، بالأخير، مجرد تعبير عن قيمة يعتنقها ويروج لها هؤلاء التسعة، بمرجعياتهم المحددة والمحدودة، قياساً إلى إمكانية واحتمالات القراءة اللا محدودة.
و لمن تمنح الجوائز إذاً ؟
أجيبك بأن القاصي والداني باتا يعلمان الكثير الكثير، مما كان مستتراً، بشأن دور النمذجة والقولبة والسير على النهج الإبداعي المطلوب، من مجتمع ثقافي معين، في لحظة مجتمعية وحضارية بذاتها، لتمرير أجندة فلسفية ومجتمعية وجمالية وسياسية، بعينها، فضلاً عن دور الشللية وجماعات الرفاق والمنتفعين وتجار النشر وصبية الدكاكين الصحفية والثقافية، المنتشرين كالجراد على موائد الكرام واللئام، في الترويج، الممنهج المستمر، لنماذج إبداعية بالخصوص، إنفاذاً لأهداف الأجندة السابق الإشارة إليها.
لعنادك الدائم أسئلك أخيراً، عن الكيفية والغايات أو عن الوسائل والأهداف من الجوائز؟_
لعل الإجابة عنهما مضمرة في ثنايا كلامي السابق كله، بشكل أو بآخر، أخيراً دعني أقول لك وللقارئ على حد سواء، دعونا نتذكرأن تاريخ الجوائز، بشكل عام، وحتى على مستوى الجوائز العالمية الكبرى كنوبل، ليس مشرفاً جداً، ودعونا نتفق على أن المبدع الحقيقي لا يشغل باله، ولا ينبغي له أن يشغل باله بمثل تلك الأمور المعوقة، في الحقيقة، لإبداعه، وهو ما يعرفه هذا المبدع،أكثر من غيره، ومهما تظاهر، أحياناً، ولضعف إنساني مفهوم المنشأ، بغير ذلك، بين الحين والآخر.
_ إذاً، ماهي رؤيتك للوجود الذاتي والكتابي الإنساني في هذه اللحظة التاريخية الفارقة والمضطربة ؟
أخشى أن هذا العالم لم يعد المكان الآمن الصالح لا للحياة، ولا للموت الطيب الرحيم. وحتى قبل بلوغي سن الستين، فلطالما عبرت عن خوفي هذا بشأن محنة الاستمرار في الوجود، وبرغم الاتهامات، الشفوق، أو القاسية، أو حتى المتهكمة، من لدن أولئك الخيرين الطيبين الرحماء والإيجابيين الذين يبقون على إيمانهم بالحياة، كما بالقوى الحكيمة اللا منظورة التي تُنشئها وتحفظها وترعاها وصولاً إلى غاياتها المزعومة، بحسب اعتقادي الشخصي، والذي لا أطالب أي أحد بتشاركه معي، بالمناسبة. حياة في عالم يعصف بكينونة الفرد، ويسحق الجماعات والشعوب، ويطمس الهويات، كما تعبرون بدقة، وفوق ذلك، يتجاسر على ادعاء الفضيلة والعدالة والدفاع عن الحريات وإشباع الحاجات الإنسانية وتحقيق الذوات، في عملية نفاق وخداع إيديولوجية رخيصة مُستدامة. عالم لا يمكن له الزعم بأنه خير العوالم الممكنة، وبرغم هذا أسمع، كل ساعة، من يلومني على تربية النفس على ضرورة تعلم التخلي عنه. وهكذا، وكلما
_ وعن تلك السنوات من العزلة والوحدة والفردانية ، حدثنا عن جدوى الكتابة وأفراحها؟
بل وخيباتها أيضاً فقد مضت بي السنون، أجدني مقهوراً على معاودة التأمل في صورة الكونت تولستوي، وهو يجلس في ظل شجرة، بإحدى غابات ضيعته يوسنايا بوليانا، يُصلح ويرتق أحذية أقنانه، أو يؤلف كتب القراءة والكتابة الرشيدة لتعليم الفلاحين الأميين مبادئ فك شفرة الحروف، عازفاً عن تكرار خيبات تجارب كتابة الأدب العظيم، كما في "الحرب والسلم" أو "آنا كارينينا"، ومجيباً على توسلات تورجنيف له، بالكف عن إهدار تلك الطاقات العظيمة، لكنز الأمة واللغة الروسية الخالد، في هذا الهزر غير المقبول، بالقول لأن حذاءً في قدم عارية لفلاح أجدى من كل إبداعات شيكسبير".
أستعيد صورة تولستوي وكلماته، وأتساءل عمَا يُضفي على حياة الإنسان من معنى، وعمَا يسلبها المعنى، عارفاً أنه ما من إمكانية لتحقيق الذات في غيبة إدراك الذات لما هي عليه، حقاً، كما في غيبة إيمانها بما ينبغي لها أن تكون عليه، حقاً، وأخيراً في فقدانها سُبل مزج الإدراك بالإيمان، أو ما هو كائن بما يُفترَض كونه.
_ وماهو السبيل وكيف يكون الخلاص فيما يخص مواقفك وبنيتك الفكرية والثقافية المعرفية؟
أجل، فما من سبيل، حتى وإن كنتَ الكونت تولستوي ذاته، لمعاينة المعنى الأسمى لوجودك، ما لم تُحدد، لنفسك وبنفسك، مفردات هذا المعنى وخرائطه؛ فإمَا الاستمرار، كما معزى تشيكوف، باجترار ولوك الورقات، اليابسات التافهات، المُشبعة براوئح أحبار الطباعة الثخينة، ودهس الأعشاب الخضراء، والزنبقات البيضاء، بالحوافر الطائشة السوداء، وإمَا ركوب مخاطرة الهروب بليلٍ جليدي، والموت، برداناً محموماً، على رصيف محطة قطار، نائية منسية، لاعناً مسيرة مُظفرة للكلمة، اختلست من العمر نحو ثمانية عقود طويلة رهيبة.
قضى تولستوي موقناً، على الأرجح، أنه ما مِن معنى حتى لرجاء اجتراح المعنى، أو أن موت الأدب شرط لقيامة الحياة، وتلك هي المسألة!
وماذا عن جديد المبدع المتمرد والرافض للصخب بل والعامل في صنت وعزلة السارد حسني حسن؟
عندي عدة كتب، أو فلأقل بدقة مشاريع كتب، جاهزة للنشر ولا تحتاج سوى بعض التنقيحات وإعادة ترتيب المواد داخلها، وهي كتب تتوزع ما بين القصص القصيرة، والمقالات النقدية، والشذرات التأملية، وكذا، ويا للغرابة، تجارب في كتابة قصيدة النثر. أما المشروع الرئيس الذي أخطط لإنفاذه، إن سمحت الظروف والصحة، خلال الشهور المقبلة، فهو استكمال النص الروائي الطويل، والذي كنت قد توقفت عن كتابته قبل نحو عقدين من الزمان بسبب عملي الدبلوماسي وسفري الطويل. أرجو أن أتمكن من العود، ولعل العود دائماً أحمد.






















