مدخل لتحديث الثقافة المصرية «١-٣»
لا تكاد تخلو مرحلة من مراحل تطور نظام يوليو ١٩٥٢ من خطاب حول الثقافة، والمثقفين، ودورهم الوظيفى فى التقدم، والتنمية، وتطوير الوعى الاجتماعى، والسياسى. ثمة تشابهات عديدة بين هذه الخطابات والمراحل، وكان الحاكم عند قمة النظام يطرح آراءه حول المثقفين قدحًا وذمًا، أو دعمًا مع توجيههم إلى دعمه، ونظامه باسم الأمة، أو الشعب.
كانت العلاقة بين الثقافة والمثقف، والسلطة ملتبسة، وكان الإدراك الرسمى السائد تاريخيًا، أن دورهم هو دعم سياسات النظام، وأنهم إحدى أدوات أشكال الغضب الاجتماعى، ومن ثم كانت رقابتهم أساسية، والقبض على بعضهم واعتقاله لانخراطهم فى أحزاب سياسية محجوبة عن الشرعية القانونية والسياسية الرسمية، من ثم كانت العلاقة مع الثقافة، والمثقف موضوعًا للريبة لدى الحاكم، وأجهزة الدولة الأمنية. من هنا كان الحصار وفرض السياجات على دور المثقف ورأيه فى أجهزة وزارة الثقافة، إلا لمن والاه، وفى الصحف، والإذاعة، والتلفاز، ودور النشر حيث الرقابة على الجميع، الموالين، والمعارضين، ومن ثم انضباط الخطاب الثقافى.
لا شك أن وضعية الثقافة المصرية، محملة بفائض من الأزمات الممتدة، ومن ثم مستقبلها محفوف بالمخاطر فى ظل تحولات الثقافات الكونية المتعددة فى ظل الذكاء الصناعى والرقمنة والروبوتات، وأيضًا فى ظل ظاهرة موت السياسة مصريًا وعربيًا.
سنتناول أوضاع الثقافة المصرية بين الحاضر والمستقبل فيما يلى:
أولًا: الخطاب حول الثقافة: الجمود النسبى.
ثانيًا: ملاحظات أولية حول أوضاع الثقافة المصرية المتغيرة.
ثالثًا: الثقافة الرسمية: الأزمات المستمرة.
رابعًا: الفجوات بين الوعى والإدراك السلطوى، وبين تغيرات الثقافة عالميًا.
خامسًا: الثقافة المصرية وصدمات التغيير.
سادسًا: بعض من السيناريوهات المحتملة.
سابعًا: أى السيناريوهات محتمل.

١- تعانى الخطابات السائدة حول الثقافة المصرية، من المقاربات العامة والسائلة، دونما ضبط للمصطلحات، والمفاهيم المستخدمة، وغالبًا ما تكرر فى غالب هذه الخطابات، التى يغلب عليها التأمل والانطباعية، والأحكام القيمية المرسلة التى يمكن أن تقال، أو تكتب فى عدد المراحل التاريخية عن مشكلات الثقافة، والمثقفين، بقطع النظر عن التغيرات الجيلية، والاجتماعية، والسياسية والاقتصادية، وأثرها على التطور الثقافى عمومًا، وعلى الجماعات الثقافية، وعصبها وشللها. غالبًا هذا النمط من الخطابات، ما يركز على الثقافة الرسمية، وسياسة السلطة الثقافية، إزاء المثقفين، وتحديدًا جماعة الأدباء من الروائيين والقصاصين، والمسرحيين، والشعراء، ومواقفها السياسية إزاء السلطة السياسية، والسطة الثقافية، وأجهزتها المختلفة، فى المجلس الأعلى للثقافة، واختياراته فى جوائز الدولة، ومؤتمراته وندواته، أو هيئة الكتاب، وسياسة النشر- إن وجدت- وهيئة قصور الثقافة، والمسرح، وكذلك الأمر بالنسبة لجماعة الفنانين التشكيليين، ومعارضهم فى قطاع الفنون التشكيلية، وفى اقتناء أو عدم شراء بعض أعمالهم الفنية. الأمر أيضًا ينسحب على الجماعة الموسيقية، على الرغم من أنهم غالبًا لا يميلون إلى النقد الحاد، أو الصوت العالى بالنظر إلى طبيعة عملهم، وحصولهم على الأجور مباشرة فى بعض الأحيان.
حينما يثار بعض المشاكل فى جماعة الأوبرا، وغيرها من التابعين لأكاديمية الفنون الجميلة، من الأساتذة فى بعض الحفلات الرسمية بخصوص الأجور، والمكافآت.
هذا النمط من الخطابات، يدور فى المدارات الرسمية أساسًا، وغالبًا ما تركز كل جماعة على اهتماماتها الخاصة فى نظرتها، وإدراكها لمشاكل الثقافة المصرية فى كل مرحلة من المراحل التاريخية، والسياسية، ويعاد إنتاج هذه النظرات الفئوية الجزئية، والسطحية لأنها تنطلق من تصوراتها لمصالحها الضيقة، ومشاكلها فى هذا الإطار.
٢- بعض هذه النظرة الجزئية من الجماعات الثقافية، المختلفة تدور حول مقارنات بين الواقع المتغير اجتماعيًا، وثقافة هذا المتغير، التى تخالف أذواق، وكتابات، وموسيقى، وأغانى بعض هذه الجماعات الذين عاشوا معها، ومارسوها فى العقود الماضية، والتى سادت فى أجيالهم أو الأجيال السابقة لهم، وثمة موقف من فهم أعمال الأجيال الجديدة فى عديد المجالات من الكتابة للموسيقى للغناء للأفكار، وحتى اللغة التى كانت سائدة فى العقود التى تكونت فيها ثقافتهم، ونوعية التخصصات التى أنتجوا خلالها!
٣- الملاحظ أيضًا أن الجميع يركزون فى خطاباتهم حول الثقافة إلى مناط الضيق المتمثل فى الفنون التشكيلية، والأدب، والمسرح، والموسيقى، والغناء، والسينما، والتمثيل.
من ثم لا يهتم غالب هذه الخطابات بالثقافة بالمعنى العام والأنثربولوجى الشامل، أى ثقافة الشعب بالمعنى العام الواسع للثقافة. من هنا يعتبر بعض هؤلاء أن الخطاب حول الأزمات، أو المشكلات الثقافية فى تخصصه، يمثل ثقافة الشعب، وأن فئاته تستهلك هذا الإنتاج، وهذا ما يمثل نظرة جزئية، ومختلفة عن ثقافة الشعب، والذى قد يستهلك بعض الغناء، والأفلام، والموسيقى الشرقية للأغانى أساسًا، وبعضهم كان يشاهد المسرح والمسرحيات فى المسارح، أو فى التلفاز، أما بعض الفنون التشكيلية لا تستهلكها سوى قلة القلة وبأعداد محدودة، وكذلك السرديات الروائية والقصصية والشعر، والكتابات النقدية فى هذه المجالات على اختلافها، وهم قلة من القراء لبعض هذه النظرات السائدة، والجزئية وتركيز بعضها على مجالات إنتاجها، وعملها، تشكل فى ذاتها أزمة فى مقاربة الثقافة، لأنها ماضوية، وجزئية، والأهم تنطوى على فجوات بين ثقافة القلة، وبين ثقافة الشعب، والأهم أيضًا أنها تركز على الثقافة المسيطرة سياسيًا، وتتناسى المكونات المنسية أو المحجوبة لثقافات المكونات الأخرى فى المجتمع لا سيما ذات الطابع العرقى الأمازيغى والنوبى، تحت سطوة مفاهيم الدولة الأمة، والقومية المصرية، على الرغم من بعض التفكك الذى اعترى مفهوم الأمة فى ظل التسلطية السياسية، وأيضًا للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على وهن استراتيجيات التكامل والاندماج القومى، خلال العقود الممتدة من هزيمة يونيو ١٩٦٧ إلى عصر مبارك، ثم إلى اللحظة الراهنة، التفسخ فى الأنسجة الاجتماعية، وتآكل الموحدات القومية، والشروخ أدت إلى حالة من النكوص إلى ثقافة بعض هذه المكونات، وأيضًا امتداد ذلك إلى بعض المكون القبطى المصرى كنتاج للأصولية الإسلامية، والراديكاليات الإسلامية، والمشاكل «الطائفية»!
٤- من هنا لا نستطيع فقط تحديد مشكلات الثقافة المصرية على المفهوم الضيق ذى الطابع النخبوى الرسمى، وحتى من هم خارج السلطة الثقافة الرسمية وعلى هوامشها! إنما بروز الفجوة بين ثقافة الشعب وثقافة القلة، وبين الثقافة المصرية، وتحولات الثقافات العالمية/ الكونية المتعددة! وبينها وبين الثقافات العربية، تحت وهم أنها «القوة الناعمة» الأساسية عربيًا، مع أن استخدام هذا المصطلح إلى الآن دلالة على الماضوية، والأوهام السائدة رغم تغير معنى دلالة المصطلح!
إذا أردنا تحديد بعض معالم الأوضاع الثقافية المصرية، ومشاكلها يمكننا مقاربة كلا المفهومين للثقافة وفق معناها الضيق، وفى إطار معناها الواسع، ثقافة الشعب، وذلك مع مراعاة، أثر الواقع الافتراضى على الثقافة المصرية كلا المعنيين، خاصة فى ظل بعض التقارب بين مستهلكى كلا المستويين من الثقافة، من الفئات الاجتماعية المختلفة على نحو ما سوف نشير إليه لاحقًا.

مفهوم الثقافة من أكثر المناطق غموضًا، وتحولًا، وكان هناك تمايز بين المصطلح الألمانى حضارة، وبين المصطلح الفرنسى ثقافة، الأخير الذى ساد منذ أوائل القرن العشرين. من المكن ملاحظة أن الثقافة رغم تعريف تايلور الواسع لها، أنها تنطوى على عمليات للتغيير والاستمرارية، مع التطورات العلمية والتقنية والاقتصاية، والفنية، والأدبية، وفى العلوم الاجتماعية، والتغير الاجتماعى Social change من الملاحظ أن هذا المفهوم، يطرح فى الخطاب السائد من منطلق سكونى، وكأن الثقافة جزء من مفهوم الثوابت النقلى الدينى الذى يسود فى الفكر الدينى النقلى التقليدى الإسلامى- وهناك تشابهات فى الفكر اللاهوتى المسيحى الأرثوذكسى- مصدر هذا الإدراك السكونى أو شبه الثابت لمفهوم الثقافة، أن كل جيل من الأجيال ينظر إلى مرحلته أو المراحل السابقة- لدى بعضهم- وكأنها هى الأفضل ثقافيًا، سواء فى نظرته لإنتاجه الإبداعى، أو الثقافة العامة التى كانت تسود هذا الجيل، أو ما يليه أو من قبله على أنها الأهم، أو الأفضل، وهو أمر يكشف عن نزعة سكونية فى النظر إلى الثقافة بمعناها العام، أو الضيق، فى حين أن كليهما فى جمودهما، أو تغيراتهما هى تعبير عن تغيرات مستمرة رغم بعض الاستمرارية فى القيم، والأساطير، والمرويات، ونظام الأكل، والزى، والموسيقى، والفلكلور.. إلخ! حتى بعض هذه المكونات يحدث بها بعض من التغير، مع التغيرات- السوسيو- اقتصادية والسوسيو- سياسية، والتقنيات، وتأخذ أشكالًا مختلفة، وهو ما يشكل تغيرًا، ومع ذلك لا يزال بعضهم يتصور أن شيئًا لم يتغير، أو أن التغير يسير نحو الأسوأ، كما فى مقارنات مراحل ما بعد يوليو ١٩٥٢، بالمرحلة شبه الليبرالية، أو مقارنات ما بعد ٢٠١١، بمرحلة الجمود فى عهد مبارك لثلاثين عامًا مضت. ثمة إغفال لعلاقة الثقافة المصرية. بالإقليم العربى، أو بالثقافات الكبرى فى العالم وتحولاتها فى ضوء تطور العلوم، والتقنيات، والثورات الصناعية، والعلمية، والمعلوماتية، والرقمية، والذكاء الصناعى للثورة الصناعية الرابعة.
فى ضوء هذه الملاحظات الأولية يمكن طرح ما يلى حول واقع الثقافة المصرية:

١- تراجع الثقافة الرسمية، وذلك لارتباطها تاريخيًا بعد يوليو ١٩٥٢ بأجهزة الدولة الأيديولوجية، ومن ثم كانت جزءًا من تحولات الأيديولوجيا والسياسة فى مصر، وتحولاتها، من الاهتمام بها فى عصر عبدالناصر، وإدراك أهميتها أن التهميش المتدرج من عهد السادات لخصوماته السياسية مع اليسار والناصريين وبعض الليبراليين النقديين، ومع المثقفين تحديدًا إلى عهد التسعينيات وما تلاها بجوائز الدولة، ومؤتمراتها إلخ.
فى ظل الجمود السياسى طيلة ٣٠ عامًا، ثم التراجع بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، وفى ظل حكم الإخوان والسلفيين، ثم بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، حيث أثر اضطراب مراحل الانتقال على الاهتمام السياسى بالثقافة.
٢- صمت المثقفين لصالح الداعية الدينى، والناشط/ الداعية الحقوقى الممول خارجيًا.
٣- جمود وتكلس وترهل المؤسسات الثقافية الرسمية، وضعف مستويات الموظفين، والعمال من حيث التخصص، والأداء، والكفاءة، والاستثناءات محدودة.
٤- ضعف ميزانية وزارة الثقافة، التى يذهب غالبها إلى بند الأجور والمكافآت من ٨٤٫٦٪ فى ظل الحكومات الأخيرة بعد ثورة ٣٠ يونيو.
٥- ضعف مستويات الإدارة الثقافية، وفقدانها القدرات، والأهلية الخلاقة فى المشروعات الثقافية.
٦- هامشية دور المجلس الأعلى للثقافة، فى التخطيط لسياسة ثقافية فعالة، وحركية. إلا فى مجال منح جوائز الدول.. وخاصة فى المؤتمرات العربية للشعر والرواية.
٧- غياب تصورات لدى الوزراء فى المراحل الانتقالية، إلى رؤى، وسياسة ثقافية، والاستثناء تصور جابر عصفور.
٨- الخلط، والتشابه فى وظائف هيئات الوزارة مجال النشر مثالًا، وشبحية أداء هيئة ثقافة الطفل، حيث تبدو لا نشاط لها إلا قليلًا!
٩- تراجع مستوى التعليم فى أكاديمية الفنون مقارنة بمراحلها الأولى التأسيسية، سواء فى العمليات التعليمية، أو فى منح الدرجات العلمية، وغياب مشاركة فعالة لغالب أساتذتها فى مسار الثقافة المصرية.
١٠- تحول جوائز الدولة إلى جوائز جامعية لأساتذة الجامعات، وبعض المبدعين وفق تحذيرات اللجان والمجلس الأعلى للثقافة، والفنانين، وأساتذة الجامعات، بدون مشاركات فعالة لأغلبهم فى مسار الحياة الثقافية المصرية.
١١- الطابع المركزى لعمل هيئات وزارة الثقافة وأنشطتها التى تدور حول المركز/ العاصمة، وبعضها القليل فى الإسكندرية، وبعض القليل القليل فى المحافظات، مع قصور وهامشية أنشطة هيئة قصور الثقافة، بالنظر إلى ضعف الميزانية، وغياب رؤية لعمل الهيئة، وسيطرة البيروقراطية، والكسل الوظيفى.
١٢- غياب الطلب السياسى على الثقافة، وهامشية دورها فى السياسات العامة، فى ظل الضغوط الاقتصادية، والاجتماعية.
١٣- تراجع الطلب الاجتماعى الفعال على الثقافة والإنتاج الثقافى، نظرًا للتغير فى القيم الاجتماعية منذ عهد السادات إلى الآن.
١٤- تراجع القوة الثقافية المصرية فى الإقليم العربى لصالح مراكز أخرى فى المنطقة المغاربية، وفى إقليم النفط الفرعى- الجوائز، معارض الكتب، المهرجانات فى المملكة العربية السعودية.
١٥- هشاشة الجماعة الموسيقية والغنائية، وجماعة الممثلين والممثلات فى السينما والدراما، وميلها إلى العرض والطلب من دول النفط والمشايخ والأمراء منذ هزيمة يونيو ١٩٦٧، وخاصة فى عهد السادات، وتتمثل فى سعيهم وراء الثروة والمال بقطع النظر عن استقلاليتهم، ويرجع ذلك لضعف تكوينهم الثقافى بل وضحالة غالبهم، ولاسيما مع الأجيال الجديدة.
ما سبق بعض من تراجع دور ووظائف الثقافة الرسمية لانهيار دور ووظائف الأيديولوجيا، ولأنها لم تعد أداة من أدوات السلطة السياسية، من ثم أدى ذلك إلى الميل إلى الأنشطة الاستعراضية فى العاصمة، حول السلطة الحاكمة أساسًا، من ناحية ثانية شيوع الترهل والكسل البيروقراطى، فى أجهزة وزارة الثقافة، والتليفزيون، والإذاعة، والانفصال فيما بين هذه الأجهزة مع بعضها بعضًا.
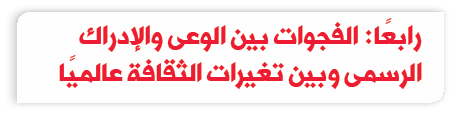
١- جزء من جمود العقل المسيطر، وخطاباته حول الثقافة أنها لا تزال تقف عند ثقافة المرحلة شبه الليبرالية، أو المرحلة الناصرية، أو فى مرحلة مبارك/ فاروق حسنى، حيث تم الاهتمام بجيل الستينيات وغالبُ كتابه ومنحهم الجوائز، وعضوية لجان المجلس الأعلى للثقافة، والسفر إلى المؤتمرات فى الخارج. من هنا تظهر الفجوة فى إدراك ودرس التغير فى الواقع الثقافى الكونى المتعدد، وأيضًا الواقع الإقليمى العربى، والواقع المصرى الموضوعى بعيدًا عن التحيزات، والنزوع إلى الإزاحة الجيلية، من جيل لأجيال أخرى.
٢- العالم منذ عقد التسعينيات من القرن الماضى وبدايات التحول مما بعد الحداثة إلى ما بعد بعدها، هناك تغير فى استهلاك وتذوق مما كان يطلق عليه الثقافة الرفيعة فى الموسيقى- السيمفونيات والأوبرا والباليه، وكبار المغنين والمغنيات، والموسيقى، والسينما، ومغامرات المخرجين المجددين الكبار فى فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والهند، وأيضا الفنون التشكيلية والمعارض، والتغير فى الأنماط الإبداعية السردية، من الأدب الأوروبى، والأمريكى إلى بدايات التحول من الواقعية السحرية وأدب أمريكا اللاتينية، وإعلامه من المبدعين الكبار إلى التجارب السردية لأدباء أبدعوا حول التناقضات بين ثقافتين، الثقافة القادمين منها إلى أوروبا- إفريقيا وآسيا والعالم العربى- وبين الثقافة التى يعيشون ويبدعون داخلها، وبلغاتها.
هذا التحول وصفه المؤرخ العظيم هوبزباوم بأنه تحول من الثقافة الرفيعة إلى ثقافة الترفيه، ومؤشراتها بدأت مع موسيقى الكانترى سايد Country Side، والراب، وانتشر فى العالم العربى موجة الراى الجزائرى، بعد جيل جلالة، وناس الغيوان فى المغرب قبلها.
ثقافة الترفيه، هى تعبيرات عن نمط استهلاك الفنون، والآداب، والموسيقى، والغناء، يمكن أن نطلق عليه نمط الاستهلاك السريع، ثم فائق السرعة، مع وسائل التواصل الاجتماعى فيما بعد.
السؤال لماذا التحول إلى ثقافة الاستهلاك السريع والترفيه؟
يرجع ذلك فى تقديرنا وملاحظاتنا إلى ما يلى:
١- التحول منذ ثورة الطلاب فى جامعتى كاليفورنيا بركلى، والسوربون بباريس وأثرها، فى النقد الأدبى الذى أبرزه جى ديبور فى مجتمع الاستعراض، بتحول كل ما هو حقيقى إلى تمثيل، ومعه مجتمع الاستهلاك والإعلانات، ثم الاستهلاك المفرط، الذى أدى إلى تشيئ الإنسان فى ظل الرأسمالة الفيدرالية هذا التمثيل، والاستعراض، والإعلانات، والتنافس على إنتاج السلع والخدمات فى مجتمع السرعة، ثم السرعة الفائقة أدى إلى سرعة الاستهلاك، والأكل السريع Fast Food، وساعات العمل إلى الخامسة ليلًا. كل ذلك أدى إلى سرعة وكثافة الاستهلاك والتذوق فى المأكل والمشرب وزاد على ذلك نمق الصورة الفوتوغرافية، والتلفازية والإعلانات السريعة عن كل شىء، بما فيها الكتب والروايات والقصص والشعر. انعكس نمط الاستهلاك بالغ السرعة على الثقافة، والسلع الثقافية، حيث تم تسليع الثقافة وباتت رهينة العرض والطلب عليها، وخاصة بين الأجيال الجديدة فى أمريكا وكندا وأوروبا، قبل وبعد انهيار الاتحاد السوفيتى، والكتلة الاشتراكية، حيث تمددت عمليات التسليع إليها، بعد تبنى النظام الرأسمالى، ونيوليبرالية.. كل شىء بات خاضعًا للعرض والطلب، وغواية الإعلانات، والصورة. باتت الثقافة سلعة، ومن ثم سيطر عليها نمط الاستهلاك السريع مع الثورة الرقمية، والسرعة الفائقة فى استهلاك المنشورات، والتغريدات، والصور، والفيديوهات الطلقة، والميل للانكشاف لدى الجموع الرقمية الغفيرة والتعبير عن نفسها، حدثت نقلة نوعية وثقافية، جد مختلفة عن تطورات الفكر والفلسفة، والأدب، والموسيقى، والغناء، وسيطرت لغة رقمية جديدة مختلفة، وأنماط من التعبير الفنى، والموسيقى، والغنائى، والكتابى.
أحد أبرز آثار ذلك أن القراءة السريعة والنظرة فائقة السرعة، والالتقاط السماعى فائق السرعة مهيمن على السلع الرقمية المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعى، وهو ما أثر على قراءة الأدب رفيع المستوى، والإبداع، لصالح كتابات وجيزة وسريعة القراءة والاستهلاك، وإلى السطحية، والتبسيط.
تحولت السلع الترفيهية الاستهلاكية الثقافية إلى جزء من العرض فى السوق الرقمية، ومعها أجيال شابة تستهلك هذه الأنماط، وتشارك فيها، وهو ما أثر على الفنون الرفيعة، وأنماط استهلاكها ومستهلكيها للأجيال الأكبر سنًا، وبعض من الأجيال الشابة الجديدة.
٢- الاستهلاك لم يقتصر فقط على الإنتاج الثقافى الترفيهى، لكن استهلاك ما كان يطلق عليه «النجوم اللامعة» فى السينما وفى الدراما التلفازية، والمطربون والمطربات، وإنما شمل هنا النجوم، وبات استهلاكهم سريعًا لمدة أربع أو خمس سنوات ثم سرعان ما تغيب عنه الفرص، بعكس تاريخ السينما إلى السبعينيات، وأوائل الثمانينيات. الآن الاستهلاك لهؤلاء بات سريعًا، ومن ثم تتراجع فرص العمل لديهم لصالح آخرين من الأجيال الجديدة، والوجوه الجديدة.





















