الروائيون المغاربة الشباب.. روايات فذّة تنبت في جبال الأطلس

"الرواية هي ملحمة الطبقة البرجوازية" بمعنى أن الرواية هي الصوت الأدبي السردي للطبقة التي انبثقت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر وأطاحت بطبقة النبلاء، ومقولة إن الرواية هي صوت هؤلاء البرجوازيين تُنسب لهيجل، ونجد لها امتدادًا عند المجري جورج لوكاش (1885 – 1971) في كتابه "نظرية الرواية". حيث يقول: "الرواية هي الشكل الأدبي الأكثر دلالة في المجتمع البرجوازي".
وبتبني هذه النظرية لهيجل ولوكاش وغيرهما، يمكننا فهم سبب تأخر ظهور الرواية المغربية الأولى إلى منتصف القرن العشرين، إذ لم تكن الطبقات البرجوازية قد تشكّلت في المجتمع المغربي، والذي كان بالكاد قد حصل على استقلاله في 1956.
ولذلك ربما ظهرت الروايات المغربية الأولى، متكئة على نصوص سردية مستوردة، إما من الغرب (أوروبا)، أو من الطرف المشرقي من العالم العربي، وبالتالي جاءت النصوص السردية الطويلة المغربية الأولى، بعيدة بعض الشيء عن روح الرواية بمفهومها الحديث، فكانت أقرب إلى الرواية التاريخية، أو إلى السيرة الذاتية، أو تدوينات أدب الرحلة.
في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي بدأ ظهور النصوص السردية الطويلة الأولى في المغرب، لعل أبرزها "الرحلة المراكشية" لابن المؤقت المراكشي (1882 – 1949)، و "الزاوية" للتهامي الوزاني (1903 – 1972). ويمكننا هنا ملاحظة أن كليهما كتبا النصوص السردية قادميْن من حقول معرفية أخرى، فابن المؤقت كان عالمًا بالحديث وكتب في التاريخ والتصوف، أما التهامي الوزاني فهو فقيه في المقام الأول، كما أنه منتمٍ إلى أسرة صوفية في الأساس.
لاحقًا، بعد ذلك بسنوات، ستظهر الروايات المغربية الأولى مثل "وزير غرناطة" لعبد الهادي بوطالب (1923 2009) وقد صدرت في 1950، و "في الطفولة"، وهو نص سردي طويل يراوح بين الرواية والسيرة كما يتضح من العنوان، لمؤلفه عبد المجيد بن جلون (1919)، وصدرت في 1957. ثم "سبعة أبواب" لعبد الكريم غلاب (1919 – 2017)، وصدرت في 1965. ويمكن اعتبار النصوص الثلاثة، هي الأعمال التأسيسية للرواية المغربية.
ستتوالى بعد ذلك الروايات المغربية، وستظهر أسماء مثل محمد عزيز لحبابي (1922 – 1993) ومبارك ربيع (1935) قبل أن يظهر العلمان الكبيران محمد شكري (1935 – 2003) ومحمد زفزاف (1945 – 2001).
وفي الثمانينيات من القرن الماضي ظهرت أسماء مثل أحمد المديني (1951) والميلودي شغموم (1947) ومحمد عز الدين التازي (1948) وبنسالم حميش (1948).
ثم في التسعينيات برزت أسماء مثل محمد الأشعري (1951)، وعبد الكريم الجويطي (1962)، وزهور كرام (1961)، وفي العقد الأول من الألفية الثانية برزت أسماء حسن أوريد (1962) وعبد العزيز الراشدي (1978). وفي العقد التالي ظهرت أسماء جديدة مثل محسن لوكيلي (1978) ومحمد بنميلود.
"الدستور" تخصص الملف التالي، لطرح شهادات للروائيين المغاربة الشبّان، الذين نشروا باكورة أعمالهم الروائية في العقد الثاني من الألفية الثانية. مجموعة من الموهوبين الذين يكتبون بالعربية من أقصى غرب العالم العربي. إنهم الدفعة الأحدث في الكتابة المغربية. صوت طازج قادم من جبال الأطلس.

"لأنني لم أمتلك سعر تذكرة طائرة تسافر بي إلى أي مكان".. عبد المجيد سباطة
*روائي ومترجم مغربي من مواليد الرباط (1989)، من رواياته "ساعة الصفر"، و "الملف 42".
أعتقد بأن من سيفكر بالعودة إلى حواراتي السابقة، باحثا عن إجابة واضحة لسؤال الكتابة، سيجد نفسه أمام إجابات مختلفة، وربما متناقضة أحيانا، لا لشيء سوى لأنني في الواقع لا أعرف ما هو السبب الحقيقي أو الأوحد الذي دفعني أول مرة لحمل القلم، وكتابة أسطر تحولت فيما بعد إلى رواية، وليقيني أيضا بأن الرواية أصلا سؤال، لا إجابة!
أحب الحبكات الروائية المعقدة، وأهيم بلوحات البازل التي تجتمع قطعها المتناثرة لتقدم صورة مكتملة، لذلك أرى بأن الكاتب في داخلي نتاج تفاصيل حياتية مختلفة، أولا كوني وحيد والديّ، ما ساهم في تقوية علاقتي بالكتب منذ سنوات طفولتي الأولى، وأيضا شحذ ملكة الخيال التي يوفرها ذلك العيش الدائم بين سطور الأعمال الروائية والأدبية بشكل عام، كما أنني مررت بظروف شخصية معينة، لها علاقة بمساري الدراسي والمهني (والعاطفي؟ ممكن!)، ساهمت جميعها في لجوئي إلى الكتابة، باعتبارها الدرع الوحيد الذي أعانني على تحمل صعوبات الحياة ولا منطقيتها في الكثير من الحوادث والمنعرجات غير المتوقعة.
أتعامل مع كل كتاب جديد يقع بين يدي بمنطق تحقيق أقصى استفادة ممكنة، لذلك أعتبر نفسي أيضا، نتاج ما قرأت بالمجمل، ولن أجيب أبدا عن سؤال "من هو الكاتب الذي تأثرت به؟" بتقديم اسم واحد فقط، لا أستطيع أن أمر مرور الكرام أمام جيش من الأسماء التي حفرت بأقلامها وأظافرها، لتصنع تاريخا من حبر وورق، وتتركني مبهورا منقطع الأنفاس أمام قوة كلماتها وأفكارها، أكتب مستلهما هدوء دوستويفسكي وجدية ألكسندر دوما واستمتاع بول أوستر وأناقة إيتالو كالفينو، مرورا بمراوغة خوليو كورثاسار وحربائية فرناندو بيسوا وهوس جورج بيريك وعبث روبرتو بولانيو، وصولا إلى التزام نجيب محفوظ وعناد عبد الرحمن منيف وعزلة ربيع جابر وبوهيمية محمد زفزاف.

تلقى النقاد رواياتي باهتمام كبير، حيث وجد فيها عدد منهم محاولات جادة لتقديم أساليب جديدة تغني الرواية العربية وتقدمها بطريقة مختلفة، فنشرت عدة مقالات نقدية تتناول تفاصيل "ساعة الصفر" و "الملف 42" بالدراسة والتمحيص، كما سعدت بتشجيع بعض أساتذة الأدب المتخصصين لطلبتهم الجامعيين للاشتغال في مشاريع تخرجهم على رواياتي، بما يتجاوز النظرة الضيقة لآخرين، ممن فضلوا التعامل مع أعمالي بمنطق التجاهل أو الهجوم المباشر، انطلاقا فقط من حداثة سني أو عدم انتمائي لأي تيارات أو أحزاب أو اتحادات ثقافية، وهذا مألوف للأسف عند البعض، ممن اعتادوا على الشللية في الميدان الثقافي، ويعتقدون بأن الأسلحة الصدئة التي حاربوا بها بعضهم بعضا في السبعينيات والثمانينات، مازالت صالحة للاستخدام اليوم، لكن نهر الزمن الجاري أثبت سذاجة هذا التصور، وكان شعاري ومازال، ببساطة عملية حسابية لطلبة السنة الأولى الابتدائية:
"ما دمت قادرا على الكتابة، فسوف أكتب..."
تأثرت كما الجميع بالجائحة، التي طرقت أبوابنا بلا استئذان، ثم أجبرتنا على تحمل ضيف غير مرغوب فيه اسمه كورونا، ولذلك صرت ميالا أكثر إلى العزلة، وإن كنت غير متحمس لفكرة كتابة عمل تدور أحداثه في زمن كورونا، لعلمي بأنني لن أضيف شيئا لكل ما قيل وسيقال، فقط أفكر وربما يقودني حدس ما إلى الاعتقاد بأن مغامرتي الروائية القادمة سيحكمها إطار مكاني ضيق، بعدما "سافرت" في أعمالي السابقة إلى مناطق ودول من مختلف أنحاء العالم، ما دام ذلك دافعا إضافيا للكتابة، ربما نسيته بداية، هو أن من بين الأسباب التي دفعتني للكتابة، عدم امتلاكي وقتئذ سعر تذكرة طائرة تسافر بي إلى أي مكان!

"الكتّاب هم أول حركة صديقة للبيئة في التاريخ".. سكينة حبيب الله
*شاعرة وروائية وقاصة مغربية (1989)، من رواياتها "بيت القشلة" صادرة في 2016.
شيءٌ ما يحول بيني وبين النّبش في حكايتي وإخراجها ثم تقديمها في رواية. فأنصرفُ عنها إلى حكايات الآخرين. كلّ روايةٍ أكتُب هي منديلٌ أربطُه ليكوّن حبلاً، سأستطيع بعدَ – عُمر طويل – أن أمدّه لنفسي كي تخرج من البرج الذي حُبسَت فيه، ونلتقي أخيراً ونفهم بعضنا أو من يدري ربّما نتعارك. كتاباً بعد آخر، أفهم جزءاً يسيراً من تاريخي، ويظهر لي من بعيد ما أظنّه خيالاً لمن كنتُ أو سأكون.
روايتي الأولى كتبتها في الهواء لسنين قبل أن تتحوّل إلى نصّ مكتوب. بدأ كلّ ذلك بصورة وجدتها صدفةً في عليّة البيت. الصّورة لشاب يجلسُ في طائرة حربيّة ضخمة، يريحُ يديه على فوّهة بندقية يتعكّزها. النظرة في عينيه تترك في النّفس أثر تأمّل لوحة "الصّرخة" لمونش لوقتٍ طويل دون أن ترمش. لاحقاً عرفتُ أنه جديّ وتلك الصّورة كانت بعد الإقلاع من مطار هانوي أيّام الحرب الهند الصينية (لاندوشين). بقيتُ أخبئ الصورة تحت وسادتي وأتامّلها كل ليلة. أتأمّل يديه وعينيه وأبكي. وعبر عينيه – كما قالت دوراس – رأيتُ انعكاس نفسي. كان جدّي قد توفي وأنا في الخامسة من عُمري ولم يكن ثمة من وسيلة لمعرفة ما حصل قبل أن يركب تلك الطائرة ولا ما حدث بعد أن هبط منها. أظنّ أن الرواية تأتي من هذا المكان: من الشّعور القوي أن الحقيقة ليست في يدك، وأنها حتى وإن كانت كذلك، فهي أبداً لن تكون كافية. بدأتُ أقرأ وأبحثُ عن قصص المغاربة في الفيتنام. تعلّمتُ القليل من اللغة الفيتنامية. خطّطت للسفر إلى هناك.
ثمّ عدلت عن ذلك. وعوضاً عن ذلك بدأت الكتابة. لا عن جدّي. بل عن المغاربة الذين حاربوا في الفيتنام. عن لعبة التاريخ التي كالدمينو، تُسقِط جيلاً بعد جيل.

الكّتاب في رأيي، هُم أوّل حركةٍ صديقة للبيئة في التّاريخ. باستعمال الخيال يحوّلون الأشياء المؤذية وغير المؤذية، منتهية الصّلاحية والمعطوبة إلى مادّة رائعة قابلة للتحلّل في أرواح البشر تسمّى القصص. كي تتحرّك الرواية أمامي، يتوجّب على قوة أخرى خارجية أن تأخذ على عاتقها مهمّة نفخ الروح فيها. الأمر يشبه إلى حدّ كبير زراعةٍ عُضوٍ في جسد. فور أن تجد الصّورة- الصّوت – الرّائحة مكانها في قلبي، تدبّ الحركة في اللّغة وتتدفق الحجارة والأنهار من أماكن متفرقة في رأسي وذاكرتي ويصيرُ بوسعي أن أكتُب. كالمُعلّم جيبيتّو، أجلسُ في ورشتي، في انتظار أن يدخل علي المعلّم أنطونيو وفي يده قطعة الخشب لآخذها منه وأراقب تحوّلها بين يديّ من خشبٍ صرف إلى دُمية فكائن حيّ يكذب ويتألّم ويشتهي ويقرّر.
حين أعود بالذاكرة إلى الوراء أجدُ أنّ أوّل قصّة اخترعت كانت وأنا في الثالثة أو الرابعة من عُمري. حين وقفتُ ونظرت في عيني والدي بثقة لأخبرهما أني لستُ من بلّل فراشي في الليل. بل كائنات تعيش في السّماء.
أخبرتهما أنّ الوقتَ صيفٌ وليس بوسع تلك الكائنات أنْ تُمطر. فدخلت عبر النافذة وطلبت مني أن أسمح لها باستعمال سريري كحمّام فوافقت. ولأن سريري كان ملاصقاً للنافذة التي تظلّ مفتوحة بسبب الحَرّ أيامها فقد اعتبرتُ حبكتي بلا ثغرة ما جعلني أنا نفسي أصدّقها لوقتٍ طويل. اليوم. وبعد سنواتٍ على هذه الحادثة، ما زلتُ أقوم بالشيء نفسه – لا أقصد أني أبلّل فراشي طبعاً – مازلتُ أخلقُ شخصيات لتتحمّل بالنيابة عني مسؤولية الحقيقة والواقع الذي يُشعرني بالعار والخجل.

"سادية الآلهة... مازوشية الإنسان".. طارق بكاري
*روائي مغربي من مواليد مدينة ميسور (1988)، من رواياته "مرايا الجنرال"، و "نوميديا"، و"القاتل الأشقر".
صوّبني حدسُ الصبا نحو الكتابة. منذ وقت مبكر شعرتُ أن ترويض الخيال لغةً هو أكثر ما أجيده، صدّقتُ هذا الحدس الذي أشرقتْ به طفولتي، انتبهتُ مبكرًا إلى أن الحكايات التي كانت تحفني هي دروس كتابة، أن شغف القراءة درسُ كتابة، أن الحياة -وهذا هو الأهم- بمآسيها، بقسوتها عليّ، بخيباتها قرابينُ ضرورية لأكون ما سأكون.. كنتُ أشعرُ -ولا أزال- أن كلّ خطوةٍ أخطوها، كل حماقة أو خطيئة، كل مجدٍ أو تجربة إنما هي أمور تصوّبني نحوَ الكتابة..
ثمّ إن الكتابة كثافة سحر، هوسٌ بالتفاصيل الصغيرة، رؤى بكر تتجلّى على الورق، هي تلك الدهشة التي نغزِلها بصبرٍ وأناة لنورّطَ غيرنا فيها، هي الحياة التي نمنحها للكلمات، تحرير الخيال وتشكيله.. لطالما كانت الكتابة بالنسبة لي مناسبة حريّة، لذلك أقبلُ عليها كمن يغادرُ سجن واقعه، ولهذا كتبت بتطرف ودون أصفاد، كتبتُ بعيدا عن حسابات الربح والخسارة !
تورّطت في الكتابة حين أدركتُ أنّ حكاياتنا كبشر ليست طوع أيدينا، هذا الوعي الشقي بأننا بمعنى ما أسرى نصوص لم نقرأها، ولا نحن نملكُ سلطان إدارتها كما نشتهي، ورّطتني فيه حكاياتنا الأمازيغية التي كنتُ أقطفها طفلا من فم جدّي وجدّتي، الإنسان حرّ بالقدر الذي لا ينتفض فيه على نصّه، والحياة، ما الحياة سوى مسرح كبير نتقفى فيه أثرَ نصوص خُطّت سلفًا، وما الإنسان سوى ممثل صدّقَ دوره.. تقول حكاياتنا الأمازيغية أننا كبشر مداد حكايات خطّها الحظ، الإله، القدر أو لنقل منطق العالم، أو نظام الأشياء.. ديكتاتورية هذا النظام، وسادية الألوهة هذه كانت ملهمةً لي في كل ما كتبت، في الكتابة -والفن عمومًا- نملك ترَف أن نرى الأشياء من علٍ ولا نرى، الكتابة تمنحنا مساحة لخلق عوالم موازية وإدارتها، تمنحنا فرصة أن نرَى الحياة، من زاوية الآسر لا الأسير..

بمنطق الآسر كانت الكتابة مناسبة حرية، وبمنطق الأسير العالق في حياة لا يفهمها، وجدتني مدفوعًا إلى الكتابة، كانت الكتابة عزاءً خاصًا عن كل الخسارات التي أولمت لي الدنيًا. أعتقد أنّ الكاتب هو حالة تتعانقُ فيها سادية الآلهة بمازوشية الإنسان، حاولت في روايتي الأخيرة "روائح ديهيا" (2021) أن أفككّ هذه العلاقة الملتبسة التي تجمعني بالكتابة، وأن أهرّبَ للقراء شيئا منّي باسم مستعار، فالكتابة عندي طفلة هذا البؤس الشخصي، لأن السعداء عندنَا مثل السياسيين لا يختارونَ الكتابة إلا نادرًا، وحينَ يفعلون فإنما ليكتبوا أشياء رديئة!
لم يكذب بطل روائح ديهيا حين قال: "أحيانًا أعتقد أن ما يدفعنَا إلى الكتابةِ ليسَ نبوغًا وحسب، بل إن خيباتنَا وأحزاننَا هي مسوداتنَا الأولى لكلّ عملٍ أو عملٍ محتمل، ما الكتابةُ إلا محاولة يائسةٌ لالتقاطِ زجاج الآخرين من لحمنَا بعدَ أن أدمتنَا حادثةُ خيبة، الكتابةُ طريقةٌ لنعزّي أنفسنَا ونقول على نحوٍ مشفّرٍ ومكابر كل آلامنَا، في الأخير وراءَ كلّ مبدعٍ جرحٌ كبيرِ يحاولُ عبثًا أن يضمّدهُ بأوراقٍ يرى فيهَا تميمةً ضدّ الحزن..."

"محاولة لمغربة السرد".. عبد السميع بنصابر
*روائي وقاص مغربي من مواليد قرية "المعدن الأصفر" بنواحي مراكش (1986)، من رواياته "خلف السور بقليل"، و "ذيل الثعبان".
لستُ أتذكّر تحديدا متى ولا أين قررتُ أن أكتب.. ربّما لطول عهدي بذلك.. فقد كانت أولى محاولاتي نصوصا سردية بسيطة، اختارها أحد أساتذتي للنشر على صفحة المجلة الحائطية، خلال المرحلة الدراسية الثانوية.. لكنّني أتذكّر –بكل تأكيد- بعض الدوافع التي جعلتني أجترح الكتابة مبكّرا.. منها –مثلا- أنني كنتُ شغوفا بالحكايات الشفهية التي كان يبرع والدي في سردها، قبل أن يمضي بي حبل الزمن، لأبحث عن لذّة القصّ هاته بين صفحات الكتُب..
لا يمكن أن نتحدّث عن الإبداع الكتابي دون استحضار المطالعة.. ولعلّ بعض المحطات من تجربتي ككاتب، كانت تحكمها نسبيا دائرة المقروء التي تحيط بي خلال كل مرحلة.. وقد أصدرتُ روايتي الأولى "خلف السور بقليل" سنة 2013، رغبة مني في إثراء مكتبة الرواية المغربية، عبر مؤلف يتكئ على "مغربة السرد"، التي دشنها –قبل ذلك- كُتاب كبار من أمثال "محمد زفزاف"، "إدريس خوري" و"الأمين الخمليشي".. في محاولة للخروج من جلباب "الرواية الشرقية"، التي ظلت ترخي بظلالها على الإصدارات المغربية عقودا.. هكذا، كانت الحاجة إلى الانعتاق من هذه الهيمنة الرمزية، باستدعاء شخوص وأجواء محليّة، في قالب روائي اجتماعي ترفده تركيبة لغوية، تشغل المسافة الفاصلة بين الأسلوب الفصيح واللهجة العامية.. لأن اللغة تدخل ضمن الاستراتيجيات المهمة التي يتبناها الكاتب، إلى جانب عناصر فنية أخرى، للتعبير.. هذه العناصر تفرضها تيمة النص المكتوب. فالموضوع يبحث له عن الشكل الذي سيخرج به، بداية بالجنس الأدبي وانتهاء بتركيب الجملة..
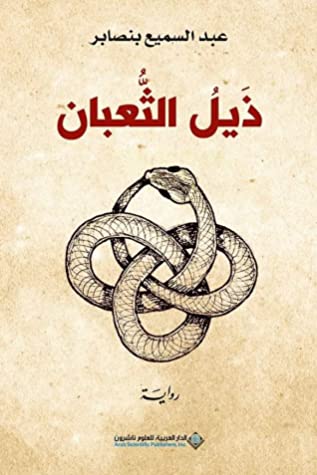
في روايتي الأخيرة "ذيل الثعبان"، حاولت أن أثور على نفسي قليلا، وأخالف المنحى الذي طبع منجزي الروائي والقصصي سابقا، من خلال الاشتغال على موضوعة التاريخ.. ولإيماني، أيضا، أن الأدب قد يكون وسيلة رفيعة لمساءلة تاريخ البشرية. وقد أمضيتُ وقتا طويلا في التنقيب بين ثنايا التاريخ عن شيء لا أعرفه.. أهي الحقيقة؟ بالتأكيد لا! إذ ليس من اختصاص الأدب البحث عن الحقائق أو إنتاجها.. هذا لو سلّمنا بوجودها أساسا.. بل إن الأدب يسائل عقائد الناس الحتمية.. ولست ممن يقتصر في الكتابة على نقل الوقائع.. فالرواية –في اعتقادي دائما- وسيلة لخلق حيوات جديدة، عبر إعادة تشكيل الفضاءات والشخوص، وفق تصوّر وذائقة المبدع.. أما عن الواقع وما يمكن أن يغير فيه الإبداع، فتلك مسألة مُلقاة على عاتق التاريخ والتجربة. فالمبدع ليس مُطالباً بتدبيج وصفات خلاص مُعلّبة لتجاوز الأزمات والمشاكل. ربّما تلك مهمّة المُصلح والفقيه والعطار وكل من يرى في نفسه مُخَلِّصاً للبشرية. الإبداع يمنح القارئ متعة ولذة روحية ثمينة. كما أنه يذكي الحرقة والسؤال في أعماقه. فهو لا يحتاج الكتبَ ليعرف واقعه. طبعاً، هذه ليس هرولة من الواقع إلى البُرج، كما قد يُفهم من كلامي. فالكاتب ينطلق من واقعه المشترك مع الآخرين بكل تأكيد، لكنه لا ينقله كما هو، بل ينفعل ويتفاعل معه من رؤى وجدانية وفنية مختلفة..

"اكتشاف للعالم وللذات".. كريمة أحداد
*روائية وصحفية مغربية (1993)، صدرت لها رواية "بنات الصبار".
لطالما أحببتُ القصص والحكايات. في طفولتي الأولى، كنتُ أنصت باهتمام ولذة للحكايات التي ترويها لنا جدتي وأمّي مطلقةً العنان لخيالي الخصب، مفتونةً بتلك العوالم العجيبة وشخصياتها وحبكاتها وتطور أحداثها ونهاياتها. كانت النساء في عائلتي راوياتٍ رائعاتٍ للحكايات، وربّما ورثت ذلك عنهنّ. فصرتُ مع الوقت، أنزوي بعيداً عن العالم مكتفيةً بورقة وقلم لأخلق قصصاً وشخصياتٍ وأقداراً ومصائر. كان الأمر، بالنسبة لي، أكثر متعةً من اللعب ونطّ الحبل مع قريناتي.
ثمّ كبرت، وصارت الكتابة بالنسبة لي متنفّساً، مهرباً من أن أوجدَ مع نساءٍ همّهن الزواج والارتباط ومشغلهنّ الأساسي النميمةُ وتوافه الأمور. أتّخذ لي زاوية في البيت، حيث أجلس لأقرأ بنهم، وكانت القراءة تملأني بكلّ أسباب الكتابة. أمّا خلقُ عوالم جديدة فكان يُشبه بالنسبة لي انغماس الأطفال في متعة اللعب.
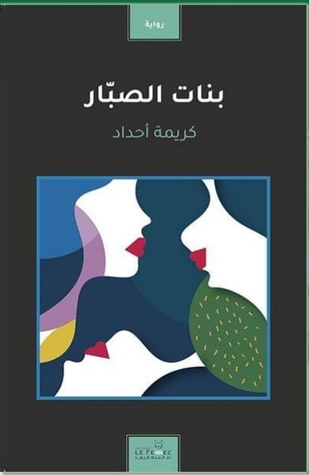
لم أنقطع عن الكتابة أبداً، رغم الالتزامات المهنية وعملي المستنزِف في الصحافة. كنتُ أتوقّف في بعض الأحيان لفتراتٍ قصيرة، لكنني أعود في كلّ مرّةٍ، ممتلئةً أكثر، لأفعل ما يتوجّب عليّ أن أفعله، ما خُلِقتُ من أجله: الكتابة. يُشبه ذلك مُدمِناً انقطعَ عن المخدّراتِ لفترة دون أن يكون مقتنعاً بذلك، وحينما يعود إلى التعاطي، يعود بنهمٍ أكبر ولذة أكبر.
الكتابة اكتشاف. اكتشاف للعالم وللذات. وخلق شخصياتٍ ومصائر يعينُك على فهم الناس من حولك أكثر. عرفتُ ذلك أكثر حين بدأت تتبدّى معالم كتاباتي وتتخذ شكلاً وتنتمي إلى أجناس أدبية معينة. بدأ الأمر مع مجموعتي القصصية الأولى التي كتبتُها في سنّ الثامنة عشرة، ثمّ مع روايتي الأولى "بنات الصبّار" التي صدرت سنة 2018. انقطعتُ بعدها عن الكتابة لسنة تقريباً بسبب الالتزامات المهنية التي استنزفتني، ثمّ عدتُ بشغف أكبر لأكتب روايتي الثانية التي ستصدرُ قريباً.


















